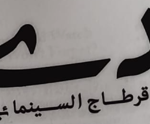بِقلم أنيس قريعة
شريط « فزاعات المنطقة الحمراء » من إخراج جلال الدين الفايزي
في منتصف عرض فيلم « فزاعات المنطقة الحمراء » (وثائقي قصير من إخراج جلال الدين الفايزي تـمّ إنجازه في إطار مشروع « رؤى متقاطعة » التابع لبرنامج « تـسيـر »)، لم أستطع أن أمنع نفسي من مراجعة قائمة الأفلام المُبرمجة للعرض في تلك الليلة لكي أتأكّد أنّه لم يقع المرور للفيلم التالي على القائمة في غفلة منّي. سرعان ما اكتشفت حينها، انطلاقا من ملاحظة حركات من جاورني من المشاهدين، أنني لم أكن وحيدا في حيرتي تلك.
قفز الفيلم دون سابق إنذار من سرد روائي الشكل وشاعري النبرة لسيرة مؤلفه الذاتية، عبر استحضاره لذكريات نشأته في المنطقة الحمراء (جبل سمّامة تحديدا)، إلى حكاية الرسّامة العصامية زينب الهلالي وعلاقتها مع ثلّة من أطفال المنطقة في ثوب وثائقي صريح. قـفـزةٌ أسلوبية مليئـة بالمخاطر لم تضع حدّا لاهتمامي بالعمل، كما كان يمكن أن يحدث، بل لعلّها كثّفت انتباهي وغـذّت فضولي لاكتشاف المزيد.
يحمل الفيلم على التفكير مرّة أخرى في مسألة كتابة الوثائقي عموما وفي العلاقة بين مذكّرة النوايا (كوثيقة مرجعية تضبط الرؤية الإخراجية) وما يراه المشاهد على الشاشة تحديدا، خاصّة وأنّ الفيلم هو نتاج إقامة فنية مُؤطّرة حول كتابة الوثائقي.
المُعتاد في هذا السياق هو أن تقود مذكّرة النوايا عمل المخرج دون أن يتسرّب نصّها مباشرة إلى خطاب الفيلم. لكن يبدو أن « فزاعات المنطقة الحمراء » ابتغى أن يشذّ طوعا عن هذا المبدأ. إذ يُنصِّب المخرج نفسه راويا منذ البداية ولا يتوانى، قبل المرور إلى الجزء الوثائقي البحت، في تبيان وثوق صلته بموضوع ذلك الجزء وعمق علاقته بفضائه وبشخوصه إلى حدّ يقترب من التماهي. وتلك النقاط هي بلا شكّ ركن أساسي من أركان وثيقة مذكّرة النوايا.
لا نعلم الكثير في الحقيقة عن ظروف وملابسات اتخاذ قرار ذلك التسرّب الطوعي. ولكن يمكننا أن نخمّـن أنّ ارتقاء النص إلى مستوى عال من الشاعرية منحته شرعية الظهور صوتيا على الشاشة، مرفوقا بمشاهد ذات طابع روائي تستعير اللقطات التأملية البطيئة التي تتشكّل منها نفس النبرة.
يعطي هذا التراوح بين الروائي والوثائقي طابعا مميّزا للفيلم ينتشله من مخاطر السقوط في أسلوب يغلب فيه البعد التواصلي على السينمائي، كما يحدث في كثير من الأحيان للأفلام المُنجزة في إطار جمعياتي. أمّا من حيث المضمون، ينجح الخطاب اللغوي-البصري دون عناء في الإقناع بصدقه ويعطي بذلك معنى للبنية المُزدوجة للفيلم.
« لقد عُدت اليوم ». لم يكن ذلك إعلان عودة فحسب من قبل المؤلف. بل بداية ثأر من « سنوات الحزن » في المنطقة الحمراء ومن كلّ فزاعاتها التي منعت ذلك الطفل المُولع بالرّسم من استكمال لوحاته على كراسات المدرسة وجدران بيته القديم: قسوة المعلم الذي « يجلده » سـتّا حين ينصرف للرسم في وقت الدرس ونهي الأهل له عن المضيّ في حلمه الفني في منطقة تُجبِر جغرافيتها سكّانَـها على تركيز كل جهودهم في مجابهة تحدّيات الحياة الأساسية جدّا.
« هل يمكن لنا أن نكون فنانين؟ »، يتساءل المؤلف. ثـمّ يسحب من صندوق ذكرياته كلاكـيتا قديمة ويسلّمها لأطفال المنطقة الحمراء، وقد كان واحدا منهم منذ سنوات قليلة. يمرّ خلف الكاميرا ويعبر نحو الجانب الوثائقي مُفسحا المجال لحكايتهم ولحكاية مؤطرتهم زينب الهلالي، التي لا تزال تطارد يوميا فزاعات تلك المنطقة، قبل أن يلتقي معهم مجدّدا في مشهد ختامي تنصهر فيه – بسلاسة منبعُها الصدق، لا متانةُ التقنية – الشخصيات وأشكال التعبير معًا فيما يشبه جبهة مُوحّـدة ضدّ الفزّاعات.
يكتمل العمل الفني هذه المرّة بفضل تظافر عديد الجهود. لكن لايزال تساؤل ثان للمؤلف يرنّ دون هوادة: « هل سيظل ذلك للأبد؟ ».