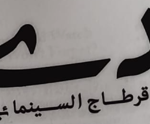بقلم محمد الفرشيشي
شريط « العصافير لا تهاجر » ِلـ: رامي جربوعي
في الأساطير القديمة، لم يكن طائر العنقاء مجرد كائن خرافي يعاود الحياة من رماده، بل كان رمزاً للروح التي ترفض مصير الجسد، وتتشبّث بالتحليق مهما كانت نهايتها الدنيوية. يستعيد فيلم التحريك « العصافير لا تهاجر » لرامي الجربوعي هذا الرمز الأسطوري، ولكن ضمن واقع تونسي قاسٍ، ليحوّل رحلة شاب مُقعَد بلا قدمين إلى رحلة روح تجد حريتها داخل عصفور صغير وتكمل، عبرَه، ما لم يستطع أن يحققه بجسده المنكسر.
يفتتح الفيلم بعين محلّقة، كاميرا تشبه طائراً أكثر مما تشبه آلة تصوير، تشقّ سماء حيّ هلال والملاسين، وتستعرض معالمه الشعبيّة: المسجد، البناء الفوضوي، لعب الأطفال، والقطار الذي يشقّ الضاحية الغربية. ليس هذا المشهد مجرّد استهلال فني، بل هو تأسيس لموقع السرد: نظرة من الأعلى، نظرة كائن يراقب العالم دون أن يكون جزءاً منه. إنها نظرة الروح التي لم تولد بعد، لكنها تستعد لتترك جسدها المعلّق في مكان ما داخل هذا الحي.
ينتقل الفيلم إلى سبخة السيجومي، محطّ رحال الطيور – النحام الوردي على وجه الخصوص – التي تجعله قبلتها من مختلف أصقاع الأرض. هناك، يجلس الشاب المقعد على كرسيه، يُعِدّ طائرات ورقيّة ويرسلها نحو الماء. ما يبدو لعبة طفولية هو في الحقيقة بروفة سرية على الطيران، محاولة يائسة لتعويض غياب الساقين بجناحين مصنوعين من الورق. دخول النحام الوردي في المشهد يضاعف القسوة: طائر كامل الجسد يسبح بين الهواء والماء كما يشاء، مقابل إنسان تخلّى عنه جسده مبكراً. هكذا يبدأ بناء الرمز: انكسار الجسد ليس نهاية الروح. تأتي لحظة البعث من الماء حين يخرج والدا الشاب من أعماق السبخة. تتجاوز هذه الصورة الواقعية لتدخل منطقة الأسطورة: ظهور من عالم آخر، امتداد لفكرة الكائنات التي تعود لتتمّم رسائل غير مكتملة. يلمّح حوارهما إلى جرح عائلي عميق: الأب في السجن، الابن مقطوع الصلة، والأم وسيط بين عالمين. هنا تصبح الأسرة نقطة الانكسار الأولى، وسبباً ضمنياً لكل انحراف لاحق في حياة الابن، بما في ذلك انغماسه في بيع المخدرات.
عنف المدينة يلتهم الشاب الذي لا يُسرق منه العصفور فقط. ظهور الشابين المجرمين المتشابهين، كأنهما توأمان خرجا من رحم الظلام نفسه، يمنح المشهد بعداً قدرّياً: كأن الشرّ يتكرّر ولا يتغيّر، وكأنه الوجه المزدوج للمدينة. يطلبان العصفور منه تحت تهديد السكاكين، لكنه يُصرّ على الرفض، ثم يحررّه رغم اقتراب النهاية. هذه اللحظة، لحظة فتح باب القفص، ليست فعل شفقة على الطائر بل فعل خلاص شخصي: إنقاذ لروحٍ باتت، على نحو غير مرئي، متحدة بالعصفور. بعد الاعتداء عليه والذي اختار المخرج ألا يراه الجمهور مباشرة، ينتقل السرد إلى رؤية من عيني الطائر تسبقها رقصات دراويش بنفس صوفي رقيق. فجأة يصبح العالم جديداً، مرتجفاً، مكتشفاً كما لو أن الروح تتعلّم جسدها الجديد. يحلّق العصفور فوق شارع الحبيب بورقيبة، يلامس كاتدرائيته وتمثال ابن خلدون، ثم يرتطم بفندق «الأفريكا» ارتطاماً يُذكّر بأن الذاكرة البشرية لا تزول رغم مغادرة الجسد. وهو ما يتجسد حين نرى انعكاس صورة الطائر. من هناك تتسع الرحلة: تمثال الحرية، المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، معالم المايا… كأن الروح تجرّب كل خرائط العالم التي حُرمت منها وهي محبوسة في كرسي متحرك على حافة سبخة. تأتي الذروة حين يصل العصفور إلى نافذة سجن الأب. هنا، تتجلى المشاعر الأكثر كثافة في الفيلم: فرح الأب بالعصفور هو فرح أب بابنه، وإن لم يُقل ذلك صراحة. يحدّثه كأنه يفهمه، يريه الساق الاصطناعية التي صنعها له، كأنما يريد إرجاعه إلى الجسد الذي تخلّى عنه. لكن العصفور يرتبك، يرفض، يغادر. لأنها ليست ساقه، ولا يعود إليها إلا من ينتمي للجسد، أما الروح -التي تحررت- فلن تعود إلى سجنها القديم، لا إلى الساق الاصطناعية ولا إلى السجن الحقيقي ولا إلى الألم العائلي.
ينتهي الفيلم بتحليق العصفور نحو الشمس. هل هي شمس الغروب أم شمس الشروق؟ لا يهم، لأنّ الأهم هو التحليق الذي لا ينقطع. الروح لا تستقر في مكان. مات الشاب، لكن العصفور يعيش. وفي هذه المفارقة، يتأكد العنوان: العصافير لا تهاجر… لأنها حين تُؤذى، تُبعث من جديد. بهذه البنية الرمزية، يقدّم الجربوعي فيلماً عن الواقع التونسي، وهي رؤية قد تُلهم المشاهد بتجاوزه نحو أسئلة كونية حول الحرية، والانكسار، والبحث عن الخلاص. يشتغل الفيلم على التمزّق الأسَري، والسجن، والفقر، والعنف، لكنه يقدّم في المقابل ميثولوجيا صغيرة -عصفوراً يطير بروح شاب- ولعلها أحد أجمل صور المقاومة وأصفاها.