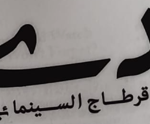بِقلم أنيس قريعة
شريط « حب ومدينة ضائعة » من إخراج ميساء المعاوي
إن لم تكن من محظوظي المدينة، كم ينبغي أن تقضي من الوقت أمام المرآة لتبتكر تعريفا ظريفا ومقنعا لذاتك الصغيرة حتى تحصل أخيرا على فرصة ما، كأن تحصل على وظيفة عادية أو أن تحظى بتمويل لمشروع فيلمك البسيط؟
أنّى لك أن تتعلّم كيف « تبيع نفسك » حسب مفردات العرض والطلب إن كنت في الأصل شاعرا تحذق تطويع الكلمات لإعادة ترتيب المعنى في مواجهة فوضى الوجود ولكنك تعجز في المقابل عن صياغة الخطاب المباشر ولا تتقن معجم السوق والتسويق وآخر ما صدر من تقنيات الـ self-branding أو حتى اصطياد المصعد الاجتماعي قبيل ارتقائه في لحظات صارت شحيحة أكثر فأكثر؟
أليس البقاء في القاع، مع سائر « الزواحف »، هو المصير المحتوم لمن تأبى نفسه الانخراط في المدّ الحضري الجارف والانصهار في نمط العيش البرجوازي؟
في مدينة تونس كما يصوّرها فيلم « حب ومدينة ضائعة » (روائي قصير بالأبيض والأسود من إخراج ميساء المعاوي من المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت)، تحمل الشاعرة الحائرة أمام المرآة اسم « حياة ». ضاقت بها الكلمات في يوم ما وهي كلّ ما تملك، فقرّرت اللجوء إلى الصورة السينمائية لتكثيف المعنى من حولها في فضاء اغترابها المزمن.
تلك كانت خطيئتها إذ وضَعَها خيارُها وجها لوجه مع إكراهات المنوال الرأسمالي للشكل التعبيري الجديد والذي يتأرجح – خلافا للشعر والكتابة عموما- بين الفنّ والصناعة، مع كلّ ما يتولّد عن ذلك من شعور بالعجز والضّآلة يعمّقه بنيان المدينة الخانق للآفاق والمتطاول على أغلب ساكنيها، على الرغم من قبحه الصارخ الذي سعت لقطات الفيلم الافتتاحية للكشف عنه.
لحظة إدراك
لا نعلم بالتحديد، من خلال الفيلم، متى كانت لحظة إدراك الشخصية لضآلتها ولحقيقة منزلتها الاجتماعية (بالمعنى الطبقي للعبارة) التي أعادها فشلُ خيارها الحالم إلى دائرة الملموس. إلاّ أننا متأكدون تماما أنّ تلك اللحظة طالت علاقتها مع شريك حياتها. شاب يبدو أنّ لهثه وراء المصعد الاجتماعي، مجدّدا، قد جعله ضيّق الآفاق. تدرّجت المشاهد التي ظهرا فيها معاً في تجسيد اتّساع الهوّة (حرفيا) بين الطرفين وسطوة الصّمت على لقاءاتهما.
لعلّ حياة أدركت بدورها أن تلك العلاقة تسحبها نحو نمط عيش برجوازي شكلي لم يعُد ينطلي على وعيها المستيقظ حديثا. نمطٌ كشف تعثّرُ مشروعها السينمائي البسيط زيفَه أكثر من أي وقت مضى.
على تخوم المدينة تتحرر الكلمة
في مُنتصف االفيلم، في غفلة من مُقتضيات خطّية الحبكة، وبعد صمت ساد في جلّ ما سبق من المشاهد تنفلت الكلمات من عقالها حين تبتعد الشخصية بعض الشيء عن مركز المدينة، كأنها تثأر للشاعرة من إحباط مساعيها السينمائية، كأنها تعاتب في الآن ذاته كاتبتها على نزوة ميلها للصورة، مع أنها كانت منذ البداية طيّعة لها دون شرط أو متطلبات.
تَمزُّقُ « حياة » بين الكلمة والصورة هو انطباع عامّ يرافق الفيلم من بدايته إلى نهايته وتَشي به، بين الفينة والأخرى، تلك اللقطات التي تصطف فيها كلمات مُسودّة السيناريو على شاشة الكومبيوتر في مفارقة صارخة. فتلك الكلمات التي يُفترض أن تتشكّل منها الصورة السينمائية، تصبح موضوعا لتلك الصورة ذاتها.
في نسق تصاعدي، يتطوّر الخطاب الفيلمي في « حب ومدينة ضائعة » إلى أن يتّخذ في مراحل نضجه نبرة احتجاجية صريحة تذكر الرأسمالية بالاسم وتتوغّل بالكلمة والصورة معًا في وصف توحّشها من خلال تشريح قاع المدينة: زواحف وبعوض، حفلة شواء وبطون نهمة، والكثير الكثير من القمامة. ثـمّ ينغلق الفيلم تدريجيا على إيحاء بصري بنبذ فردانية الذات ويكرّس التحامها رمزيا بالجماهير الغاضبة، أي ببقية « الزواحف » التي تشابهها، من خلال مشهد يستند لمبدإ الطباعة الفوقية: وجه « حياة » في الخلفية تغشاه أضواء حمراء (وذلك هو الفاصل اللّوني الوحيد طيلة الفيلم) صادرة عن ألعاب نارية يلوّح بها متظاهرون على عتبات مسرح المدينة.
تبدو الخاتمة وكأنها تبشّر بإعادة تشكّل وعي ثوري في ذهن الشخصية دون السقوط في خطاب إيديولوجي سافر، تماما كما يفعل الشعراء بالكلمة أو بالصورة على حدّ السّواء.